بالرغم من أن الرئيس الفرنسي، إيمانول ماكرون، عثر على من يسند إليه مهمة الوزير الأول، وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو، بحجب الثقة عنها في الجمعية الوطنية، أول أمس، إلا أنه في نظر المراقبين صار "رئيسا شكليا"، والأفيَد له رمزيا وسياسيا الاستقالة، وليس استهلاك الحكومات في كل مرة، مادام لم يعد قادرا على تحقيق الأغلبية البرلمانية ولا على التعايش مع التيارات المسيطرة في الجمعية الوطنية، ولا على تقديم وزير أول يحظى بالإجماع ويصمد أمام إجراء حجب الثقة، ولا على منح خصومه فرصة تشكيل الحكومة.
وانطلاقا من خصائص "بروفايل" الوزير الأول الجديد، بوصفه أقدم وزير في عهد ماكرون، وقربه الكبير منه، فإنه نسخة طبق الأصل من حيث التصورات السياسية ومقاربة إدارة الشأن العام، سيُعيد إنتاج "الماكرونية"، ولا يمكن أن يبدع مخارج سحرية خارج الصندوق، تجمع حوله الأضداد، وتعيد تشكيل ورسم المشهد، في ظل وضع اقتصادي متأزم وشارع يغلي.
فالرجل الذي عمّر في منصب وزير الدفاع لسنوات، مُقيدا بواقع سياسي مغلق منذ الصعود الكاسح لليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، ثم في التشريعيات الفرنسية، واستحالة في التعايش مع هذا التيار المتشدد، الذي صار لا يروي عطشه سوى رحيل من حرمهم من حلم الرئاسة مرتين.
وعليه، فإن تعيين وزير أول، لا يوقف الأزمة القائمة منذ الانتخابات التشريعية المسبقة العام الماضي، التي لم تفرز أغلبية حزبية وتركت الرئيس ماكرون في وضع سياسي هش، انتشله، مؤقتا، تحالف مع اليمين، ليجد نفسه مجددا أمام خيارات ضيقة، لا تخرج عن ضرورة إيجاد حكومة مقبولة لدى الكتل البرلمانية بمختلف اتجاهاتها، أو حل الجمعية الوطنية مرة ثانية، الأمر الذي يشتهيه اليمين المتطرف لاكتساحها أكثر أو الاستقالة.
كما أن السلطة التنفيذية ستظل ضعيفة أمام "برلمان" بثلاث كتل كبرى أو أربع، توجهه عمليا قوى اليمين المتطرف واليمين ومن يدور في فلكهما، بينما يظل المسؤول الأول في الـ"الإليزيه" يتحرك ضمن هوامش شبه منعدمة، ويناور بإيجاد توازنات وتحالف الرمق الأخير مع اليسار.
ويسعى الرئيس الفرنسي، حاليا، إلى إدارة الأزمة بربح الوقت، غير أن ذلك لا يغير من الواقع شيئا، بل هو إنكار له وتضييع للوقت وهدر لرصيده السياسي، في وقت دعا رئيس حزب "فرنسا الأبية"، جون لوك ميلونشون، إلى استقالته كحل وحيد للأزمة.
فيما ترى النائبة ورمز اليمين المتطرف، مارين لوبان، المخرج في تنظيم تشريعيات مسبقة، للاستحواذ على الجمعية الوطنية بالأغلبية، ومن ثم رسم المصير السياسي على يدها.
وتنمو في أحشاء المشهد السياسي الفرنسي أزمة كبيرة، شبّهها المراقبون بأزمة 1958 التي أدت إلى انهيار ما يسمى في الأدبيات السياسية الفرنسية بالجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة، وأطوارها تمثلت في اضطراب سياسي مزمن، وتصاعد التوتر في الأوساط السياسية على خلفية ثورة التحرير بالجزائر، وفشل الحكومات المتتالية في إيجاد مخرج لها.
ومهدت تلك الأزمة إلى عودة الجنرال شارل ديغول إلى السلطة، ثم انتهت بصياغة دستور جديد وإرساء أسس جمهورية جديدة بنظام حكم شبه رئاسي، لا يزال قائما إلى غاية اليوم، لكن يبدو أن صلاحيته انقضت هو أيضا، بسبب الأزمة التي تلازمه منذ سنة، بعد أن اختفت في "برلمانه" الأغلبية وتوزعت مراكز القوى وتباعدت الرؤى والمواقف بشكل يعجز الفاعلون فيه عن تحقيق التعايش، ويفسح المجال لتأثير اللوبيات وجماعات الضغط، على حساب اتجاهات الشارع ورغبات الناخبين.
ونظريا، يعتبر العديد من المراقبين أن سقوط حكومتين، في ظرف أقل من ستة أشهر، مؤشر قوي على أزمة بنيوية في "السيستام"، وتعبير عن اختلالات جوهرية في نظام الحكم بفرنسا، برزت جليا لما تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق للديون، وتراجع تاريخي في القدرة الشرائية، واحتقان وغليان كبيرين في الشارع واستعدادات لحركة "لنغلق كل شيء" لتنفيذ وعيدها.
بالمقابل، يرى آخرون أن سقوط حكومة ميشال بارنييه وفرانسوا بايرو في ظرف ستة أشهر، وقبلهما من حكومات، حالة صحية وتجسيد للممارسة الديمقراطية في أبهى صورها، ولا يعد أزمة بنيوية أو سياسية، بقدر ما يمثل خاصية في الأنظمة الديمقراطية تمنع انفراد السلطة التنفيذية بالقرار والحكم.



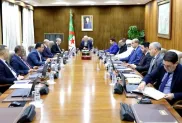





التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال